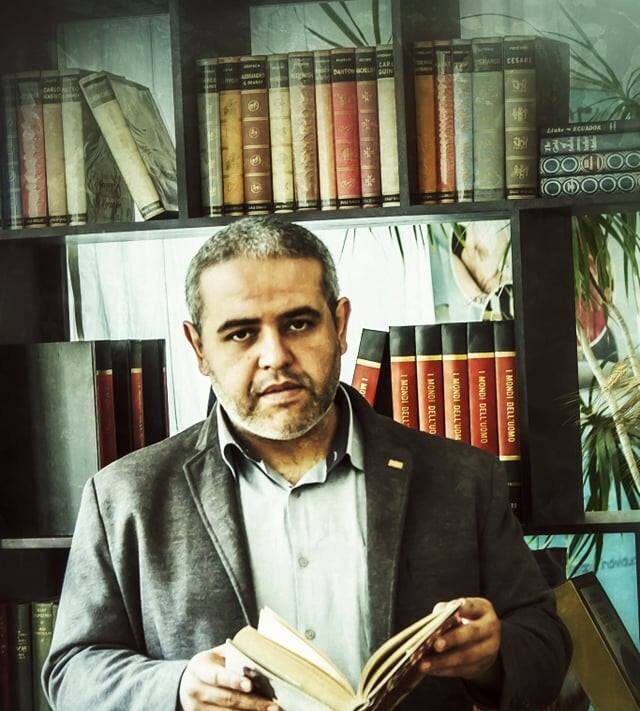منذ البدء، وما أن تدخل عالم رواية “الكلب الذهبي” للكاتب الليبي منصور بوشناف، حتى تجد نفسك في مواجهة حالة من الغرابة، لأن بطلها كما يعلن الروائي ليس له وجود حقيقي إلا في مخيلته، ثم نجده بعد استحضاره يعيش عالما حقيقيا، يحيلك إلى حالة من الألفة تدركها، وتكاد تغرق في تفاصيلها، ولكن وما أن تتآلف مع هذا الوجود الواقعي حتى تعود إلى الغرابة مرة أخرى بسبب “عدم انتظام الراوي في خط واضح وعدم التزامه بأبسط قواعد اللعب”، وهكذا دواليك..

تغمر الرواية أجواء الغرابة من كلب يتحول إلى إنسان، بفعل الحب التي يخرجك من ذاتك لتعانق الآخر، إلى منحوتات الحجر، غزالة وحورية وأفراس بحر تتحاور وتبث شكواها وتئن من الألم، الذي تعانيه، ولا يتوقف، بسبب سجنها وأسرها في حالة الجمود، بالإضافة إلى صراع تاريخي طويل بين أبطالها ـ شخصيات عالمها الروائي المتخيل، والأكثر حقيقية من العالم الواقعي، ذلك الذي تنشد خلاصه من الفوضى والتقاتل وعدم الاستقرار ولكنه ينتهي في كل مرحلة إلى خراب.
فإلى أي سردية تميل: والصراع هو القاعدة في العلاقة المحتومة بين أبطالها المتحولين بين ما كانوا وما أصبحوا، وبين المركز الحضري الهش واقعيا، والمنشود حلما، وأطرافه العشوائية الفقيرة المهمشة، وبين فساد نخبه السلطوية وضعف طلائعه التقدمية، وبين استسلامه أمام الخارج المتفوق بالتقنية والمدجج بالأسلحة أو الرعب الذي ينبثق من داخله يهدد نهارات حاضره ويملأ أحلام مستقبله بالكوابيس.
وهل هذه “الغرابة التي تثير انفعالنا ـونحن نعيش عالم الروايةـ كما يقول الكاتب (شاكر عبد الحميد) هي هنا غرابة جمالية فنية في مقابل الغرابة الحياتية، وبالتالي فموضع اهتمامنا هنا هو الجليل والمخيف وحتى المثير للرعب، لأنه مثير للاضطراب حيث توحي تفاصيل مسارات الأحداث باحتمالات وقوع المفاجآت والتغييرات العنيفة”. (1)
فما الذي ينجيك من متاهة عالمها وأطروحاتها الفكرية وانفلات أحاسيسها وغرائزها وجماليات ألاعيبها الفنية سوى خيط نور قد يمكنك من إدراك المبنى والمعنى في موضوعها الضائع المتواري خلف أحداث من تفاصيل التحول وما بعد التحول والتي تحاصرك وتضعك خارج المضامين المعقلنة.
ولذا وأمام التعقد المزدوج في موضوعها وفوضى البنية النفسية الثقافية الاجتماعية لأبطالها تزاوج الرواية بين الفن القصصي والتشكيلي والمسرحي، وتحاور موروثا شفهيا من حكايات وخراريف وأساطير الأولين، بالإضافة إلى استحضار نصوص إبداعية من الملاحم وحتى القصيدة مع قراءة في التاريخ والأنثروبولوجيا والاقتصاد السياسي.. سعيا في البحث عن الصياغة الفنية الأدبية الملائمة لموضوعها الذي بدوره يحتاج إلى إمعان الفكر والنظر، من أجل فهم واستيعاب مأزق الحالة المضطربة والمصير المأسوي الذي يهدد أبطالها والكيانـ الوطن الذي يمثل ساحة فعلهم الحقيقي.
وتستعين بكل تلك المناهل لغرض توظيفها في توسيع أفق الرؤية للتبصر في سؤالها أو أسئلتها التي تبلور جوهرها أو محورها الخاص، والذي يتقاطع عينيا مع العام ـقضايا المجتمعـ الكيان مسرح أحداثها ووقائعها ـوحيث يضطرم جدل تفاعلات أبطالها وعلاقاتهم الصراعية بهوياتهم المتعددة، المتناحرة عبر التاريخ الطويل قاتلة ومقتولة، والمتآلفة مؤقتا في الاستثناء، المتبدلة الأقنعة والمتغيرة التحالفات، والممتدة رحلتهم من كهوف العصور المطيرة في أكاكوس عابرين واحات الصحراء الكبرى لترتمي هجيجهم رجالا كلابا ونساء غزالات على ضواحي مدينة تعاني هشاشة التكوين، وتستلقي على شاطئ بحر تقذفهم أمواجه بقراصنة وحوريات، يتعايشون معا داخلها، يحترقون في فرنها الناري، وهي تنشطر إلى وحدات متوازية، كما أشار فرانز فانون في كتابه “المعذبون في الأرض”(2)، إحداها مدينة ترتدي ثيابا عصرية على نسق حضارة الخارج، وأخرى تقابلها مثقلة بسلاسل الداخل المحلي، ورغم التشابك والتداخل عبر العلاقات المحتومة المسكونة بالريبة والمخاوف، فإنها لا تتمكن من أن تحقق بتراكماتها القفزة النوعية، في بناء هوية جامعة متفتحة، بل غالبا ما ينتهي الأمر إلى خراب حيث لا ينتج سوى مسوخ تتلظى تحت هبوب القبلي أو الليبيتشو “الريح الليبي الحار والجاف”.
هكذا يستمر عالم الرواية ـ الكيان وساكنيه ـ يعاني تحولاته البنيوية، في فرن تجربة الحياة الصعبة، عبر زمن يمتد من بدء الحضور البشري في التاريخ بتحقق التحول الأولي بالخروج من الغابة إلى المشاعة محمولين على غرائزهم الطبيعية الأولى عبادا للخصب والنماء، وحتى تجلي الكينونة الإنسانية في طور وجود أكثر تطورا بالفن وبالحب إحساسا مبهجا باللذة من أجل استمرار الوجود المأسور والطامح للتحرر بمكابدة معاناة التعب من الحياة بالأنين.

يعتمد الكاتب منذ البدء سياقا سرديا بريختيا حيث يلعب “دور الراوي الذي وجد نفسه أمام جمهوره، ولا قصة لديه ليرويها: لا تفاصيل، ولا أحداث. فقط أعجوبة، أو أمثولة ولدت في مخيلتي وأنا أجلس للكتابة”، بالإضافة إلى بعض الحيل القصصية والبحث عن الغرائب، وبمخالفة لما تناوله السابقون في القصص المعتادة والمتكررة في الميراث الإنساني: تأليف أمثولة عن المسخ والتحول..
فهذه المرة، ليست ككل المرات، ليس البطل إنسانا يمسخ كلبا بل البطل كلب يمسخ بشرا..
إذن هي ليست مثل القصص المعتادة والمتكررة في الميراث الإنساني، حيث يرتكب البشر ومهما كانت مستوياتهم الاجتماعية، الخطأ لتصيبهم اللعنة بأن يمسخوا حيوانات أو أحجارا أو حشرات. إنها المفارقة!!
ويتضح مقصد الراوي حين يأخذنا إلى عالمه، عكس المسار المألوف والمعتاد، بأن يصدمنا في استسلامنا لتقاليد وعادات النظر إلى الواقع، بتحويل الشيء العادي إلى شيء غريب، أو القبول بالغريب كشيء مألوف، من أجل أن تتحقق متعة الإثارة بالحياة، ولنصبح أكثر اهتماما باللامتوقع ولكي يحررنا ويحرر الموضوع من الفهم التقليدي الأحادي، وليدفعنا الى الاندماج والمشاركة في نسجه لملحمته أو في إعداده لركح مسرحه عبر حوار جدلي مع الذات ومع أبطاله ومع المتلقي، وليكسر سردية الصوت الواحد بوسيلة أكثر تماسكا للتعمق فيما يطرح من أسئلة على ساكني الكيان في كل مراحله التاريخية، ومن زوايا متعددة متنوعة مختلفة بل ومتناقضة خلافية عقلانية ووجدانية وخيالية، تمس موروثا شعوريا جمعيا مختلطا معجونا من الغريزة حتى العقل ومن الخصب حتى الجفاف.
إنها كتابة تجريبية تحاول في كل خطوة أن تعيد بناء أدواتها لتصبح قادرة على اكتشاف المجهول الغامض الذي يكمن جوهره في تفاصيل ضبابيته وأقنعته وغبار رماله وتراكم تجاربه، والذي قد نحسبه أو نسميه قانون أسباب التحول تكوينا وسلوكا وفكرا، والذي يتحقق أو يتخلق جديدا في فرن الحياةـ الحضارة وفي أتون المعاناة التي تكابدها الكائنات أثناء التحول..
ولكن، يؤكد بوشناف “أن لحظات التحول لن تكون هامة في قصته، وبالتالي لن يتفنن كثيرا في صياغته لها، بل إن قصته نعيشها في (ما بعد المسخ) أي ما بعد التحول، وهو موضوع الرواية الرئيس.
وما أدراك بـ (المابعد)؛ فهي تدفعنا إلى أن نفتح قوسا واسعا يضم داخله مابعد المشاعة، ومابعد التصحر، ومابعد الغزوات، ومابعد الاستعمار، ومابعد الانقلابات والثورات.. فهناك تواجهنا التمزقات والعذابات النفسية والاجتماعية التي تجلت ـفي المابعدـ في الأفراد والجماعات وفي النسيج الاجتماعي الكلي للكيان، وهناك كل ما يترتب على مآلات التحول في السلوك والثقافة.
إن لحظات التحول كمية ولكن نتائجها أو الحالة التي تكون ما بعدها فهي اللحظة النوعية الفارقة.
ولذا تهتم الرواية وهي تطرح سؤالها بالشكل الفني وعلاقته بالموضوع الذي تعالجه، وتنشد توافقا أو تطابقا منسجما بين كليهما لكي تشد انتباهنا وتثير انفعالنا بالمسألة الأساس: كيف نكون، وهل بمقدورنا أن نستشرف برؤية أكثر بصيرة في المابعد مستقبلا نشارك في صنعه من هنا والآن.
إنها تستفز العقل لكي نتبصر معها وتجرح الأحاسيس لكي نعاني معاناة أبطالها، وتلهب انفعالاتنا بلحظات الحب العاصفة التي نعاني عبرها العذابات وتتحقق خلالها التحولات.
ولأن موضوع الرواية كما يرى الكاتب الكبير عبد الله العروي هو “بمثابة العقدة التي يتطلع المجتمع إلى حلها؛ والتي تعني حصيلة ما تركه التاريخ من بصمات على سلوك الناس وكلامهم ومتخيلهم، وفي ثنايا لاوعيهم”(3)، فإن الروائي “منصور بوشناف” يتوفق في اختيار الامثولة ـ الأليغوريا، مجازا مناسبا لعقدة الرواية على مستوى التمثيل والأسلوب والتركيب.
ولأن التحول ـ المسخ من الإنسان إلى الحيوان كما قدم في خراريف وأساطير الأولين وفي كتابات اللاحقين، أو من الحيوان إلى الإنسان كما يصعقنا الروائي في قصته، هو تعبير عن حالة تشظّ وتفكك، ثم محاولات إعادة البناء والتركيب، في الشكل والموضوع، في المعنى والمبنى، وبما يناسب حالة الكائنات المتحولةـ الممسوخة أو النماذج أو الرموز المتغيرة التي تعيش في مجتمعات تعاني هي الأخرى بطبيعة التغيير عدم الاستقرار والتعثر في تحقيق النهضة والحداثة ينهكها الصراع بين القوى والفئات الاجتماعية ومطامحها السياسية وأهدافها ووسائلها ومحمولاتها الثقافية الفكرية المحلية والوافدة، وليبيا نموذجا.
إنه النظر في التحول، لإدراك معاناة ما بعد التحول: كيف يتشكل المجتمع وقواه.. كيف يكون وما العمل ليخرج من حالة التشظي والتمزق والصراع مع ذاته ومع الآخر ليجد ذاته ويحقق الانسجام الوجودي الاجتماعي، ثم تصدمه النتائج والمآلات.
هكذا تعبر الرواية عما لا يعبر عنه العقل والمنطق فقط، بتجاوز حراكها لميكانيكية الخط الفكري المستقيم إلى جدل ديالكتيكي، يشمل الحواس والمشاعر والأخيلة، وحيث أن قضيتها أو عقدتها تكمن في أثر حراك التاريخ والفعل الطبيعي والإنساني على تشكلنا سلوكا ووعيا ورغبات وأحلام.. ولا يقبل التراجع الوهمي فما يتغير يتغير، و”لا شيء يرجع كما كان”.. وحتى الليبيتشو الكلب الذهبي “لن يعود إلا جديدا، آخرا، لا هو بكلب المراعي ولا هو برجل السنيورة.. لقد تعلم أن يحزن، صار إنسانا”.
ولنعيش عالمها كان لابد أن لا يكون السرد جاهزا مطواعا، كان لابد أن نقوم جميعا الكاتب والقراء وأبطالها برحلة استكشافية، زادنا بصيرة الوعي وهواجس اللاوعي، وأن نحلق بأجنحة الخيال حتى نواجه فجوات القطيعة التاريخية، ونتمكن من إدراك حالتنا الواقعية السحرية وبالتالي الانفعال بها وبما يكفي لندخل التجربة مرات ومرات، رغم معاناتنا للألم الذي قد يعقبها والتي تتم ـ كما يختم بوشناف: “في الفرن الطرابلسي ـ التي كانت ومنذ القرن الثاني للميلاد، (قرن حمار أبوليوس الذهبي)، أو (لوكيوس المسكين) وحتى هذا القرن الذي أعيش ربعه الأول، وأحاول أن أكتب (مسخا آخر) لا يزال مكانا مثاليا للتحول والمسخ.. وحيث لا تتوقف الكائنات عن التحول والمسخ عبر كل العصور، وحيث تئن دائما إما الغزالة وإما الحسناء، إما لوكيوس حمار أبوليوس الذهبي وإما بطلي، إما أبوليوس وإما أنا”.
وحيث لا نتوقف عن الحلم بكيان يعانق الحداثة والنهوض الحضاري، وذلك بالمحاولة المتكررة لتجاوز كابوس التخلف والاستبداد والظلامية، بطرح الأسئلة المتضمنة قضايا الاغتراب الوجودي والطبقي الاجتماعي، وعذابات المضطهدين الذين يعانون آلام الولادة الجديدة بفعل الحب الذي يحول بطل الرواية إلى كائن بشري، ولكن وكما يكتب الراوي “بدون أي إحساس بالانتصار ووهم الأنسنة فمصيره محكوم بالمأساة ومدمرا، وحيث لا تخصيب يتم رغم كل ذلك اللهات، يا للعبث والفراغ.
فماذا نحن فاعلون.. هل نكتفي بالرثاء.. أم نصرخ احتجاجا.. أم ثمة سبيل آخر نحاوله؟!
ـ ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـ
* منصور بوشناف، رواية ” الكلب الذهبي”، دار الفرجاني 2021
1ـ شاكر عبد الحميد: الفن والغرابة، دار ميريت 2010
2ـ فرانز فانون: المعذبون في الأرض
3ـ عبد الله العروي: من التاريخ إلى الحب (حوار)، كتاب الدوحة 29 نوفمبر 2013