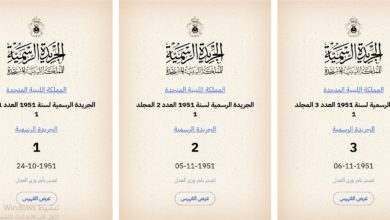* كتبت/ مروة جمعة الطيف،
أولًا، لا بد أن نقرأ ما حدث من زاوية المشهد السياسي الليبي أمام الدول الإقليمية والدولية، لا باعتباره حادثًا فنيًا معزولًا، بل كواقعة سياسية وقعت خارج الجغرافيا الليبية، وتحديدًا على الأراضي التركية، ما يفرض أسئلة أعمق حول السياق والتوقيت والفاعلين.
لقد كانت تركيا خلال السنوات الماضية لاعبًا محوريًا في المشهد الليبي، حيث قدّمت نفسها كدولة حليفة ومؤثرة، انتقلت من موقع الوسيط السياسي إلى موقع الدعم العسكري المباشر. ففي عام 2019، ومع هجوم الجيش في الشرق على العاصمة طرابلس، كانت تركيا حليفًا واضحًا للجهة الغربية، وقدّمت دعمًا عسكريًا تمثّل في الطائرات المسيّرة، إلى جانب دورها السياسي في جمع أطراف ليبية مختلفة على طاولة الحوار، وفي الآونة الاخيرة اصبحت تركيا تلتقي بالأطراف العسكرية الجهة الغربية والشرقية من البلاد .
في هذا السياق، يبرز اسم الفريق محمد الحداد كشخصية عسكرية ليبية ذات طابع خاص؛ إذ عُرف عنه أنه شخصية محايدة تحظى بقبول نسبي لدى أطراف الشرق والغرب على حد سواء، ولم يكن محسوبًا بالكامل على معسكر سياسي دون آخر. بل كان يُنظر إليه كشخصية وطنية تسعى إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتعمل على تقليص الفجوة بين الفرقاء العسكريين والسياسيين.
من هنا، يصبح السؤال الذي يتداوله الليبيون مشروعًا:
هل ما حدث هو سقوط عرضي للطائرة، أم إسقاط مخطط له؟
وحتى الاختلاف في استخدام المصطلحين “سقوط” و“إسقاط” ليس لغويًا فقط، بل سياسي بامتياز، لأنه يحدد اتجاه الاتهام ونوع المسؤولية.
هل كان الحادث نتيجة عطل كهربائي أو خلل فني؟
أم أننا أمام حادث مدبّر تقف خلفه أطراف لها مصلحة في زعزعة مسار توحيد المؤسسة العسكرية؟
وهل يمكن استبعاد تورط أطراف إقليمية أو دولية مثل الإمارات أو “دولة الاحتلال” أو السعودية، في ظل صراع المصالح والنفوذ في ليبيا؟
السؤال الأهم هنا ليس “من المتهم؟” بل من المستفيد؟
ومن له مصلحة حقيقية في إرباك المشهد السياسي والعسكري الليبي، وإعادة خلط الأوراق بين الشرق والغرب، ومنع أي تقارب عسكري أو سياسي قد يهدد استمرار حالة الانقسام؟
لقد كان “الحداد” يضم حوله عددًا كبيرًا من العسكريين، وله حضور سياسي مؤثر، وكان يمثل نقطة توازن نادرة في مشهد ليبي مأزوم. وبالتالي، فإن غيابه المفاجئ يفتح الباب أمام فراغ قد تستثمره قوى لا تريد لليبيا أن تمتلك جيشًا موحدًا أو قرارًا سياديًا مستقلًا.
وتزداد الشكوك مع تعقيدات ملف الصندوق الأسود؛ إذ يثير التساؤل رفض بعض الدول أو تحفظها على فحصه أو الإعلان عن نتائجه. فحين ترفض دول كألمانيا، المعروفة بخبرتها التقنية الطويلة في تحليل الصناديق السوداء، المشاركة في الكشف، وحين تُثار التحفظات ذاتها حول فرنسا، ثم يُطرح اسم بريطانيا أو حتى السعودية كبدائل، يصبح السؤال مشروعًا:
من قال إن هذه الدول محايدة؟
ومن قال إن لها تاريخًا تقنيًا يضمن الشفافية في هذا النوع من التحقيقات؟
إن كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولا يمكن الجزم بأي اتهام مباشر، خاصة وأن الصندوق الأسود لم يُكشف عنه بعد، لكن المؤكد أن الغموض ذاته أصبح جزءًا من الأزمة، وأن غياب الشفافية يغذّي الشكوك ويعمّق الانقسام.
في النهاية، لا تكمن خطورة ما حدث في الحادثة بحد ذاتها، بل في إمكانية توظيفها سياسيًا وعسكريًا لإشعال فتنة جديدة بين الأطراف الليبية، شرقًا وغربًا. ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع فقط على من تسبب في الحادث –إن ثبت ذلك– بل أيضًا على كل من يستثمر الغموض لإعادة إنتاج الفوضى ومنع ليبيا من استعادة توازنها السياسي والعسكري.