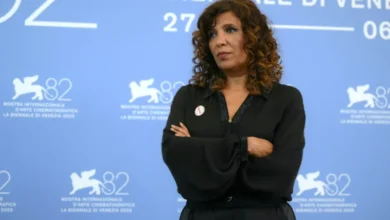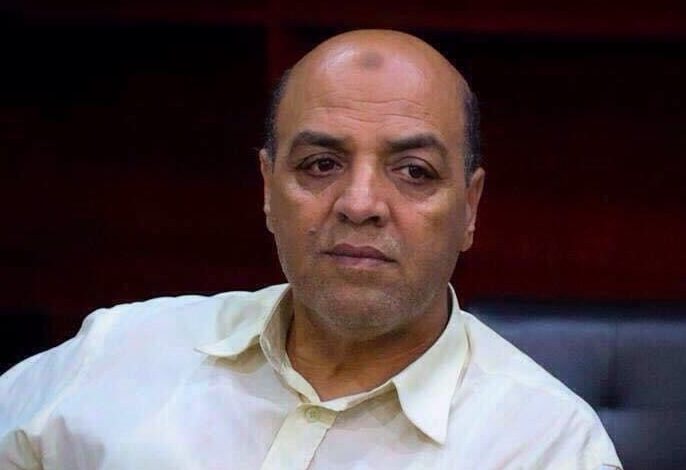
* كتب/ وحيد عبدالله الجبو،
لقد حوّل الضباط الذين قادوا انقلاب سبتمبر انقلاباً عسكرياً هادئاً إلى ما أعلنوا عنه لاحقاً ثورةً شعبية، بعد أن التحمت بهم جماهير خرجت من أحزمة الفقر والأحياء الشعبية.
وبسبب هذا الامتزاج، انتفت معالم منطق الثورة كوسيلةٍ للإصلاح المرحلي والدستوري، وحلّت محلها ثقافة تقوم على راديكالية التغيير والجزر الثوري المتشدد، بدلاً من التدرج الدستوري والانضباط المؤسسي.
بدلاً من أن تكون “الثورة” —كما أحبّوا أن يسمّوها— وسيلةً للتغيير المدروس والمضبوط اجتماعياً، صارت كلمة “ثورة” غايةً في ذاتها. العقل العام وقيادات الحركة الثورية انخرطوا في حلمٍ راديكالي للتغيير الاجتماعي، ومحاولة تطبيق نماذج وتجارب خارجية على مجتمع يتكوّن في عمومه من طبقة واحدة من الدخل والظروف. تخيّلوا وجود برجوازية في مجتمع فقير، ووجود طبقيةٍ واضحة في مجتمعٍ لا يملك إلا شكلاً واحداً من الدخل؛ مجتمعٍ فيه أحلام الفقراء من السكن والماء والعيش الكريم تتحول إلى أُطرٍ للخوض في “قصور” لا وجود لها واقعياً.
صورةٌ قديمة بقيت في ذاكرتي: كنت أمرّ صغيراً بالطريق الساحلي وأرى شعاراً مكتوباً على بيوتٍ جميلة فيقول: “طز في قصوركم”. كنت أتساءل آنذاك: البيوت ليست قصوراً، بل فيلات جميلة أو بيوت متوسطة الحال. كانت تلك العبارة تلخص المفاهيم المقلوبة في ذلك الزمن.
في تلك المرحلة تحديداً، تحوّلت كلمة “ثورة” —التي كنت أعتقد أنها فعلا ثورة، وليست انقلابا، إلى رمزٍ مقدّس في ثقافة الراديكالية الثورية، التي طغت على حركة اللجان والقيادات “الثورية”. تلك الحركات برّرت لنفسها استعمال السلاح خارج القانون، ووجهت اتهاماتٍ جاهزة ضدّ المعارضين، وصلت في بعض الحالات إلى التصفية الجسدية، لإضفاء هالةٍ عنفية على الحالة الثورية، وإثبات التفاني في “الضحية” من أجل الثورة. النتيجة الطبيعية لذلك كانت إخفاء الدولة لمسار نموها المؤسساتي الطبيعي والدستوري، إذ إن منطق الثورة الدائم يجعل الاستقرار المؤسسي مكبلاً ومشوهاً.
حملت هذه الظاهرة رواسب نفسية واجتماعية عميقة. فـ”عشّاق الثورية” رأوا في كلمة “ثورة” تبريراً لتحوّلٍ راديكالي عنيف لا مهرب منه. وانقسمت القوى الثورية إلى جناحين:
- جناحٌ عملي راديكالي لا يفهم إلا تطبيق الراديكالية بكل صورها — من اقتحام البيوت ليلاً إلى اعتقال المعارضين وخصوم الرأي.
- وجناحٌ عقائدي فكري يسعى لشرعنة أعمال الجناح الأول. على أن يعمل الجناحان لترضية القايد، وإثبات أنهم مناصرون له، وتحقيق استفادة شخصية من خلال التقرب من النظام.
وبين هذين المتطرفين —فكرياً وعملياً— لم يبرز أحدٌ بعقلانيةٍ كافية لفهم الدولة أو لترسيخ مؤسساتها، التي صارت مع الزمن مهترئةً وغير قادرةٍ على مواكبة متطلبات المجتمع، والتفاعل مع تحولات الواقع الداخلي والدولي. وقد أظهر فشلهم في قراءة العالم —خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي— عجزاً عن مواكبة التطورات الدولية وفهم موقع الدولة في المشهد العالمي الجديد.
بل على العكس، شهدت التسعينات تحولات داخلية فوضوية جعلت تغيّر هيكل الدولة سمةً مميزة لتلك المرحلة: من البلديات إلى “الشعبيات” إلى “المؤتمرات” إلى “اللجان”. تحوّلت مؤسسات الدولة على المستوى الوطني من وزاراتٍ إلى أماناتٍ مدمجة تحت مسمى “أمانة الخدمات” وغيرها، وتحولت العاصمة الناشئة إلى عاصمةٍ أكثر صغراً في قلب الصحراء.
ومع هذه التحولات، تفككت الدولة وضاعت ذاكرتها الكتابية ووثائقها الرسمية. من خلال انتقال المؤسسات والأجهزة الحكومية الرسمية ثارة في طرابلس ثم في الجفرة ثم إلى سرت.
وبدلاً من أن تُتوَّج تلك المرحلة بدستورٍ واستقرارٍ وطني، أُعيدت الدولة إلى حالةٍ من الفوضى السائلة التي لا ثوابت فيها، وضاعت معها فرص بناء مؤسساتٍ دستورية قوية. حدث ذلك في اللحظة نفسها التي كان فيها العالم الخارجي يتحول إلى واقعٍ جديد لا سابقة له: واقعٍ تجاوز الحدود الجغرافية وتغيّرت فيه نظريات الأمن الوطني والقومي، وبرزت فيه حرية المواطن والمجتمع المدني كمفاهيم أساسية.
في هذا السياق الجديد، سقطت القبضة الأمنية القديمة، وتحولت بعض المناطق والمقار إلى أدوات نفوذ تعمل على التسلق إلى السلطة من خلال تصعيد اللجان الشعبية لأجهزة الدولة، واختراق مؤسسات البلاد لتحقيق مصالحهم الخاصة في الوصول إلي مكان إصدار القرار، والتحكم في مصير الناس باسم الشعارات الثورية، وثارة أخرى باسم توجيهات القايد وتعليمات اللجنة الشعبية العامة، وما يسمي الحرص علي مصلحة الناس، وإبراز قرارات جماهير المؤتمرات الشعبية صاحبة السلطة والثروة والسلاح، وهو أمر غير واقعي وبعيد عن الحقيقة.
حين تُقدَّس “الثورة” كهدفٍ في ذاتها، وتُقدَّم الراديكالية على حساب البناء المؤسساتي والدستوري، تتحول الدولة من كيانٍ قابلٍ للإصلاح إلى ساحةٍ مفتوحة للفوضى والعنف.
والحلّ لا يكمن في إنكار رغبة الناس في العدالة والكرامة، بل في توجيه هذه الرغبات عبر مساراتٍ دستورية ومدروسة، تؤسّس لازدهارٍ اجتماعي حقيقي، دون تدمير المؤسسات أو إشعال عنفٍ لا طائل منه.