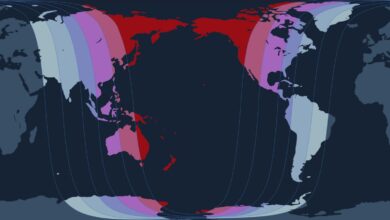* كتب/ إبراهيم احميدان
في مثل هذا اليوم من ثلاثين عاما، رحل الأديب والمفكر الليبي عبدالله القويري أحد أبرز الأدباء الذين عرفتهم الحركة الثقافية في ليبيا منذ أواخر عام 57، عقب عودته من مصر، وحتى أوائل التسعينات (1930-1992).
في ذلك الشهر الذي توفي فيه (يناير 1992) صدر عدد خاص من مجلة الفصول الأربعة، التي تصدرها رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، حمل عنوان (عاشق الوطن)، تضمن لوحة الغلاف للكاتب الراحل، بإمضاء الفنان التشكيلي المصري محمد رضا الذي كان يعمل مخرجا للمجلة، كما تضمن كتابات عن الكاتب الراحل، إضافة إلى إعادة نشر بعض النصوص الأخرى التي سبق نشرها للأديب عبدالله القويري، الذي كنت في منتصف السبعينات أتابع ماينشره على صفحات جريدة الأسبوع الثقافي، تلك الدورية الثقافية الرائدة التي تم إجهاضها من قبل السلطة أواخر السبعينات، وفي تلك الصحيفة نشرت أولى محاولاتي في كتابة القصة تحت رعاية الأستاذ القويري، الذي كان يعمل فيها مشرفا على صفحة الكتابات الجديدة، وكان يبدي ملاحظاته مشجعا وناصحا ومحفزا.
كنت أبعث بمحاولاتي عبر البريد، وفي مرحلة لاحقة تعرفت عليه، إذ كنت ألتقيه في شوارع طرابلس يسير بقامته السامقة ومعطفه الطويل، وكنت أراقبه من بعيد، وأتهيب الحديث معه رغم رغبتي في ذلك، وذات مساء تشجعت واقتربت منه.. صافحته، وقلت له إنني أكتب القصة، وسبق لي أن نشرت بعض نصوصي في صفحة الكتابات الجديدة التي يشرف عليها، استغرب استمراريتي في الكتابة، وقال لي أن الكثيرين ممن كانوا ينشرون في تلك الصفحة، توقفوا عن النشر، وربما حتى عن الكتابة، ربما كان يلمح، إلى ما جرى عقب إغلاق الصحيفة، واعتقال أبرز كتابها الشباب..
دعاني إلى زيارته في شقته في شارع النصر، وصرت أزوره بين الحين والآخر، وحين أصادفه يسير في شوارع مدينة طرابلس الرئيسية، مثل شارع الاستقلال، وشارع النصر، كنت أنضم إليه، وأسير إلى جانبه، أحادثه وأنهل من علمه وثقافته، يملأني إحساس بالخيلاء وأنا أرافق هذا الكاتب الكبير، وأشعر أن جميع الذين يسيرون في الشارع يحسدونني، ويتساءلون من هذا الشاب الذي يسير إلى جانب الأديب الكبير عبدالله القويري؟
أحببت عبدالله القويري كاتبا وإنسانا، أحببت زهده وتعففه واستقامته الأخلاقية، أحببت كتاباته التي تعبق بحب الوطن والانتماء إليه، وتنضح بالمعاناة، فقد كان يعيش غربة في وطنه، غادر مصر التي ولد بها وعاش فيها مع أسرته ضمن الأسر الليبية التي هاجرت إلى مصر هربا من الاحتلال الإيطالي، وعقب تخرجه من الجامعة، عاد إلى وطنه ليبيا مع أسرته، معتقدا بأنه طوى صفحة الغربة إلى الأبد، وإذا به يجد غربة أقسى وأشد في انتظاره في وطنه، وهو مادفعه أواخر الستينات إلى أن يحزم حقائبه ويغادر إلى تونس ليعيش بها عدة سنوات، حتى انقلاب سبتمبر، عاد بعدها إلى البلاد دون أن يتورط في مديح العسكر، كما فعل البعض، وظل محافظا على شرف الكلمة، وكان عنوانا للكاتب المنتمي بعمق لوطنه ليبيا، ودفع الثمن في سنة 73 عقب خطاب زوارة إذ تم اعتقاله وسجنه مع بقية الكتاب والمناضلين الذين سجنوا وقتها، ولقد كان لتجربة السجن أثرها على كتابات وشخصية عبدالله القويري خلال السنوات التالية لخروجه من السجن وحتى رحيله، إذ ظل مستريبا، متحفظا، متوجسا ممن حوله، خاصة الذين لا يعرفهم، وانعكس الأمر على كتاباته، وخاصة الفكرية منها، إذ راحت تتسم بالتجريد والإيماء والتلميح عوضا عن التصريح، هربا من الرقابة، وما قد ينجم عنها – يقول في مقالة بعنوان (هل التفكير عادة سرية؟): “هناك حساسية تجاه كل رأي، هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، بل يمكننا أن نلاحظ الكثيرين الذين لاهم لهم، إلا البحث عما يمكن أن يثيروا به المجتمع ضد هذا الرأي أو ذاك، غير باحثين عما يكون في تلك الآراء من قيمة، وما يمكن أن تقدمه للوطن من فائدة ووضوح واستنارة، لقد تمكن منا التوجس، حتى أصبحنا نكره كل رأي مهما كان هدفه، ومهما كان دافعه”.
كتب القويري القصة القصيرة والمسرحية والمقالة وكان الوطن محورا أساسيا في كتاباته، ولذا لم يكن غريبا أن يكون عنوان العدد الذي أصدرته الفصول الأربعة بمناسبة رحيله: عاشق الوطن.. رحم الله عبد الله القويري، سيظل اسمه حاضرا في الذاكرة الوطنية، باعتباره أحد الذين ساهموا في بلورة الهوية الوطنية، خاصة في كتابه (معنى الكيان) ستظل كتاباته ساطعة، تلهم الأجيال الجديدة بأنبل القيم والمعاني.